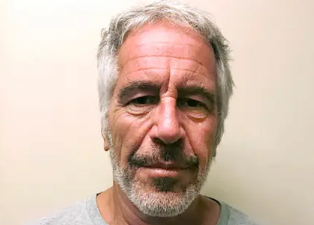بقلم / الباحثة ميادة عبدالعال
جوهر مفهومنا للثقافة التي تعني حضورا ذكيا ووجدانيا للإنسان في الطبيعة وفي الكون.وفقا لهذا التصور فإن التقدم الحضاري للإنسان يجب أن يقترن بتقدم حضور الإنسان ذاته في مجال الحياة والطبيعة والمجتمع، أصبحت القيمة العليا هي القيمة الاقتصادية بامتياز، فقيمة الأشياء، وقيمة الأشخاص تحسب اليوم بمعايير الاستهلاك وبالقدرة على الاستهلاك. وبالتالي فإن لذة الاستهلاك هي معيار سعادتنا المعاصرة. ونحن اليوم لا نزهو، كهؤلاء الرجال ما بعد الحرب، بعملنا وثقافتنا، ولسنا من هؤلاء الذين تبهرهم الأيديولوجيات السياسية وتسحرهم العقائد الفكرية، كما هو حال الأجيال المثقفة في الستينات، ولم نعد هؤلاء الذين تسحرهم شعارات الثورة والتقدم. نحن لا نريد تغيير العالم، بل نريد أن نحقق الفوائد ونستفيد. لقد تحولنا إلى أطفال المتعة الصناعية، إننا نعيش في عصر الدعاية والإعلان، والإعلان هو اليوم آخر معاقلنا حيث يتم تشكيلنا منذ نعومة أظفارنا تحت مطارقه وتأثيراته. وما تعلمنا إياه الإعلانات هو أن الحياة تعني الاستفادة والربح وتأكيد الذات. فالحياة أصبحت كالحركة في داخل صالات التلفزيون وقاعاته الفاخرة، وفي الكليب فيديو حيث كل شيء يكون على ما يرام، أو حيث كل شيء يمضي سريعا وخاطفا، حيث تكون الصورة سريعة جميلة براقة خاطفة وفي المكان الذي يلهو فيه الناس ويستمتعون.
لقد تمّ تعميدنا في مياه النزعة إلى اللذة وغمسنا في ماء الحياة القائمة على الربح والاستهلاك والإثارة. إن هاجس الحياة اليوم هو اللهو واللذة والمتعة , في العشرينات من القرن العشرين كانت ثقافة المتعة والاستهلاك ثقافة خاصة بفئة من أبناء الطبقة الاجتماعية الثرية في أمريكا، ولكنها اليوم تحولت إلى طابع ثقافي عام في مختلف مستويات الحياة الثقافية الجارية في مختلف المجتمعات المعاصرة. فما بعد الحداثة يمثل اليوم إمبراطورية القيم الأداتية، حيث تأخذ الأشياء قيمتها وفقا لمعيار الاستهلاك وتحقيق اللذة والمتعة. وهنا وفي دائرة هذه الثقافة الجديدة نجد معيارا واحدا قوامه أن قيمة كل الأشياء تنطوي في قابليتها للاستهلاك السريع وتوفير المتعة السريعة، وهذا المعيار ينسحب في جدواه على مختلف المظاهر بدءا من الكتب والأفلام والموسيقى مرورا بالعمل والإنتاج، وانتهاءً بكل مظاهر الحياة الثقافية ومستلزماتها. فالأشياء ومن أجل أن تكتسب قيمتها,وتعتمد ثقافة العولمة ” إغراءات لا تقاوم تجعل البعض يتقبل بسهولة ضغط العولمة، أو يطالب من تلقاء نفسه بإحدى منافعها الظاهرة ومثال ذلك إغراءات الحاسوب التي تتمثل في برامج وألعاب ومعلومات مذهلة للعقل الإنساني. وهناك تأثيرات الصوت والصورة والأنترنيت والأغاني والأفلام المدمجة التي تسحر العقل وتستلب لبّ الإنسان بما تمتلك عليه من قدرة وسحر وشاعرية وإبداع. وهناك التكنولوجيا المذهلة التي تخلب العقل وتستلب الوعي بما فيها من غرائب وعجائب وهلوسة وهذا عداك عن سحر الصورة التلفزيونية وقدرتها المدمرة للعقل, والثقافة وفقا لهذا التصور لا يمكنها أن تختزل إلى أبعادها المعرفية الموضوعية فحسب. إنها تتجلى في كل الصيغ عبر تحولاتها الداخلية لتتجلى في الوجدان الذاتي الأعمق لكل فرد في المجتمع، ولتأخذ حضورها المميز في ذكائه ووعيه. والسؤال هنا ما المشترك بين قراءة كتاب يصدمنا ويهز ذكاءنا وقلوبنا، وبين البهجة التي يضفيها سماع عمل موسيقي، أو بين فرحة الرسم وتصوير الروح الإنسانية في هيئة أو شكل؟ إن الرابط الجوهري بين هذه المظاهر والفعاليات فالعلوم الحديثة تنطلق من مبدأ الفصل بين الذاتي والموضوعي.
وفي سياق ذلك يتم التأكيد على الجوانب الموضوعية وإقصاء الجوانب الذاتية للمعرفة. وتعمل هذه العلوم على فهم العالم من خلال الحقائق الرياضية التي تسمح بعملية القياس والتحديد. إن التطور التقني الخالص للعلوم منقطعا عن الثقافة الإنسانية ,هذه هي الحالة المعقدة والمحيرة لعصرنا اليوم حيث يتم تعطيل الدلالات الثقافية. إنه العصر الذي يتم فيه تغييب الرؤى الشمولية والكلية للحياة، عصر التجزؤ والانشطار في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالات المعرفية، إنه عصر الفصل بين الحقول المعرفية وبين مستويات التفكير الاتصالي، بل هو عصر الفوضى الفكرية حيث لا توجد أية مصادر حقيقية لتنمية الذكاء والفهم العميق للإنسان