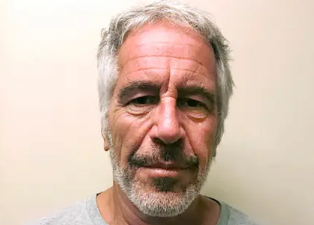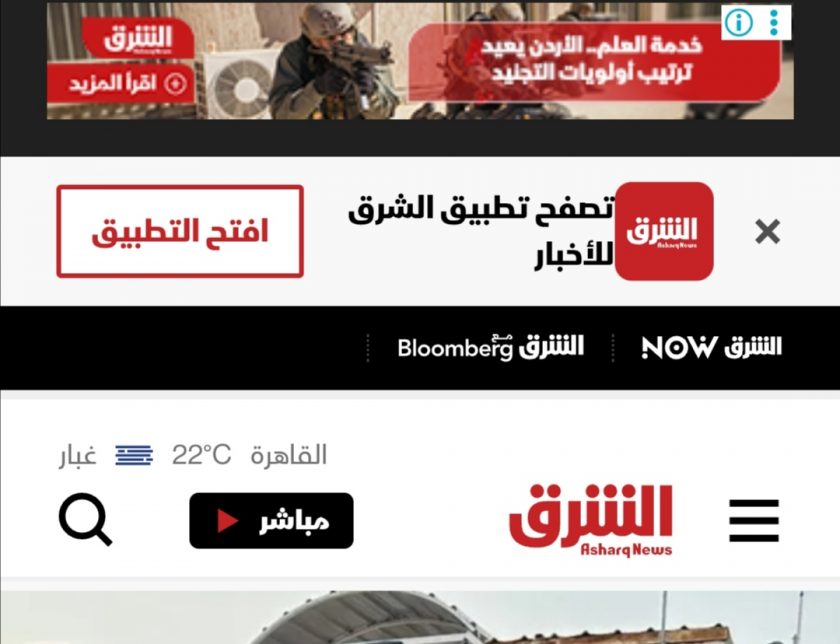أدركت فيما بعد أن قَطَرَ قد تأخرت كثيرًا في إبداع الرواية، وأنها كانت استثناءً نادرًا حين بدأ مبدعوها بكتابة القصة القصيرة، على خلاف ما هو سائدٌ في كل بلاد العالم حيث تسبق الروايةُ القصة في الظهور والانتشار. وكانت البداية نسويةً خالصة؛ حيث اشتركت الروائيتان القطريتان شعاع خليفة ودلال خليفة في وضع أول لبنة في الصرح الروائي القطري؛ فأصدرت شعاع روايتها الأولى “العبور إلى الحقيقة” سنة 1993، ثم أتبعتها في العام نفسه بروايتها الثانية “أحلام البحر القديمة”، وجاءت بعدها دلال خليفة لتخرج على القراء برواية “أسطورة الإنسان والبحيرة”، ثم رواية “أشجار البراري البعيدة” سنة 1994، ثم أخرجت روايتها الثالثة “من البحَّار القديم إليك” سنة 1995، وكان علينا أن ننتظر خمس سنواتٍ حتى تصدر روايتها الرابعة “دنيانا: مهرجان الأيام والليالي”.
وبعد هذه الروايات القطرية الست، بدأ فن الرواية ينتشر في صفوف الكتاب القطريين، فأصدر أحمد عبد الله روايته الأولى “أحضان المنافي” في عام 2005، و”القنبلة” في عام 2006، و”فازع شهيد الإصلاح في الخليج” في عام 2010، و”الأقنعة” في عام 2011، ثم بدأت خريطة الرواية القطرية تتسع أكثر، فأصدرت مريم آل سعد في عام 2007 روايتها الأولى “تداعي الفصول”، ثم أصدرت نورة آل سعد عام 2010 روايتها الأولى “العريضة”، وفي عام 2011 أصدر عبد العزيز آل محمود روايته “القرصان”.
أما في عام 2014، فأصدر الروائي جمال فايز روايته الأولى “زبد الطين“، وفي عام 2013 أصدر عبد الله عيسى روايته الأولى “كنز سازيران”، ثم أصدر في عام 2014 روايته الثانية “كنز سازيران.. بوابة كتارا وألغاز دلمون”، كما أصدر في عام 2015 روايته الثالثة “شوك الكوادي”، وهكذا توالت الروايات القطرية فأصدرت شمة شاهين الكواري في عام 2014 روايتها الأولى “نوافير الغروب”، ثم أصدرت الكاتبة أمل السويدي روايتها “الشقيقة”.
ولست هنا لأعرض تاريخ الرواية في قطر، لا إيجازًا ولا تفصيلًا، ففي كتاب “الرواية القطرية: قراءة في الاتجاهات” للدكتور أحمد عبد الملك، ما يرضي الراغب ويُقنع المستزيد؛ وإن كان قد توقف بدراسته عند حدود سنة 2014. ولكنني أريد أن أتبين موقع “ناريًّا” في خريطة الإبداع القطري، وأضع يد القارئ على قيمتها: ريادةً وفنًّا. ومكانة صاحبها في عالم الإبداع الروائي في بلاده.
ولعل القاري يندهش حين يعرف أن “ناريَّا” هي العمل الروائي الأول للأستاذ حسن علي أنواري، وهذا ما يغفر له أكثر ما يمكن أن يؤخذ عليه، وسوف يشتد عجبه حين يفرغ من قراءتها والمتعة بها. صحيح أن كاتبها واحدٌ من المثقفين الكبار في وطنه، وأنه يشتغل في عالم الكتب والمكتبات والإعلام، وأن له كتابًا متميزًا سمَّاه “رائحة الكتب: سيرة ذاتية بعبق القراءة”، وسوف أعود إليه بعد قليل، ولكن هذا لا يكفي ليخلق منه كاتبًا روائيًّا متمكنًا؛ إلا إذا كان موهوبًا في الحكي الشائق والسرد الجذاب، وهو ما أثبته بقوة في باكورة رواياته.
لا أدري على وجه التحديد كيف اختمرت هذه الرواية في ذهن صاحبها خاطرًا فخاطرًا، ولا كيف اكتملت تفاصيلُها على الورق فصلًا بعد فصل، ولكنني أزعم أن فكرتها راودته منذ فترة بعيدة، وأن الأحداث التي تدور من حوله هي التي دفعته دفعًا إلى كتابتها. أمَّا فكرتُها وشكلها فربما يرجعان إلى قراءاته المتأنية في التاريخ القديم، وربما نرجِّح هذا حين نعلمُ أنه قد خصص في الفصل الثالث من كتابه “رائحة الكتب” عن قصة نشأة الكتابة عبر «ألواح سومر»، التي وصفها عالم الحضارة السومرية «صمويل كريمر» بأنها إنجازٌ كبير ومذهل لعلوم القرن التاسع عشر وللإنسانية»، لتكون المفتاح الذي ينقل للأجيال المعارف والعلوم. فأحداثها تدور في العراق وما حوله مكانًا، وقبل ميلاد المسيح بما يقرب من ثمانية وعشرين قرنًا من عمر الزمان. يدلنا على ذلك شخصية “جلجامش” وهو أحد أبطالها، و”بابل” و بيبلوس” وهما من أهم الأماكن فيها.
● عرضٌ موجَزٌ لأحداث الرواية:
تبدأ الرواية بمشهدٍ غير إنساني، تتبدَّى فيه وحشية حاكمٍ ظالم ومستبد، يُدعَى “ينماخو”، لا تعرف الرحمة طريقًا إلى قلبه القاسي، ولا يتبين العدل سبيلًا إلى عقله المظلم. لا يسمح لأحدٍ أن يعارضه، ولا يُجيزُ لمخلوقٍ أن يناقشه. لقد كان من قبلُ كاهنًا يدَّعي محبة الناس، ولكنه انقلب على حاكمه بثورة دموية، تحول من بعدها إلى متجبر طاغية، وكما يقول المؤلف، فإن الكهنة عندما يكونون في المعبد يكونون في غاية الرحمة والرقة، ولكن ما إن يمسكوا بصولجان الحُكم فإنهم يتحولون إلى مجرمين.
ولم تكد الأمور تستقر له حتى أمر بإعدام كل من يعارضون حكمه ولا يعترفون له بأنه ظل الإله “دموزي” في الأرض. وكان الحكيم “إيليم” أكثر هؤلاء الخارجين عليه شُهرةً وأعلاهم صوتًا وأقواهم تأثيرًا، فأصدر تعليماته بصلبه في ساحة المعبد الأكبر، فدفعوا به وهو مثقلٌ بالقيود والأغلال التي وضعت في عنقه ورجليه، وهناك رفعوه إلى الصليب، وسملوا عينيه، وثبتوه بمسامير دُقَّت في كفيه وقدميه، وبسلاسل طوقت خصره ورقبته. ولما رفض أن يستجيب لهم ويتراجع عن موقفه، أشار الملك إلى قائد الحرس الكهنوتي فسحب لسان “إيليم” بكماشة وقطعه بسكين، وأخرج قلبَه من صدره. ساعتها نظر إليه أحد تلاميذه وهو يقول باكيًا: ” لقد غربت شمس الحكمة عن أرض ناريَّا، وغاب ضوء النهار، ولم تبقَ سوى الظُّلمة”.
لكن شمس الحكمة لا تغرب، وضوء النهار يغيب، والظلمة وإن طالت فسوف تزول؛ صحيح أن الملك “ينماخو” أمر بإعدام القادة الخارجين عليه، والحكماء الذين لا يعترفون به ملكًا، كما أمر بملاحقة الفارين منهم حتى لا يتمكنوا من بث روح الثورة عليه في أي مكان؛ لكن الأقدار اختارت “نسحو”، ابن الحكيم “إيليم”، ليكون خليفة أبيه ووارث حكمته، وهيأت له الأسباب لينشر مبادئه وتعاليمه، وليكون سببًا قويًّا في إشاعة الخوف والرعب في نفس “يمناخو” وأتباعه. إن الملوك إذا حكموا قريةً أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وقد يخيفون الناس بقوة السلاح الباطشة، فيطيعونهم مرغَمين، ويهتفون باسمهم مجبَرين؛ لكنهم لا يستطيعون أن يكتموا صوت ضمائرهم، ولا يقدرون على قتل كلمة الحق التي تثور في نفوسهم.
استطاع “نسحو” أن يفرَّ بأعجوبةٍ إلى بلاد الشمال، موطن قبائل أخواله، ويقيم هناك ضيفًا معزَّزَا مكرَّمًا على خاله ، الذي يهيئ له الأسباب ليلتقي برفاقه وتلاميذه ليعلمهم حكمة أبيه. ثم لم يلبث أن انتقل إلى مدينة “بيبلوس” الفينيقية ـ جبيل اللبنانية الآن ـ وهي واحدةٌ من أقدم المدن المسكونة في العالم، تختلف عن “ناريَّا” اختلافًا كبيرًا؛ فلا معارك ولا صراعات سياسية، وإنما سعيٌ وراء التجارة التي لا تزدهر إلا بالسلام بين مختلِف المدن الفينيقية، ومتعة بالرفاهية التي جعلت الناس يقبلون على تعلم الحكمة ويرفعون من شأن الحكماء.
وهناك تعلم “نسحو” الدرس الأكبر الذي تمنى أن ينقله لمواطنيه في “ناريَّا”، وهو الرقي والانفتاح على الآخر، وتقبل الآراء المختلفة؛ فهذا ما يفتقر إليه الناريون المتعصبون والمنغلقون على أنفسهم. هناك أيضًا رأى ما أدهشه وأثار إعجابه، فملك “بيبلوس” قد جعل إلى جوار قصره دارًا لتلقي مظالم المواطنين، خصصها ليضمن للشعب حقوقه، حتى لا يتعرض أحد أفراده للظلم.
وفي الوقت الذي كان “سحنو” ورفاقه يتعلمون الحكمة ويطلبونها أين وجدوها، كانت الأمور تمضي على نحوٍ آخر تمامًا في “ناريَّا”. كان “ينماخو” قد فقد أكثر قواد جيشه، وأعظم حكماء مملكته، فصار بلا قوةٍ ولا عقل، وجعله هذا مطمعًا لأعدائه، فانتهز “جلجامش”، ملك بابل، هذه الفرصة وأمر قواده أن يغتنموها ليستولوا على النهر الشمالي والقرى الزراعية حوله، وقد كان هو الآخر حاكمًا مستبدًّا، وصل إلى سُدة الحكم بعد أن انقلب على صديقه الطيب العادل “أنكيدو”، وأعلن عبادة مردوخ، ولم يكن أحدٌ من قادته أو مستشاريه يجرؤ على معارضته، وكلهم يعلمون أن الموت المحقَّق هو مصير من ينبس في مجلسه ببنت شفةٍ ليعارض أو يجادل.
واستطاعت قوات “جلجامش” أن تغير على القرى الجنوبية في ناريَّا، فباغتها القائد “أوروك” وجنوده في جنح الليل، وانقضوا على أهلها كالذئاب الجائعة، فذبحوا الرجال ذبح الخراف، وساقوا النساء سبايا ذليلات؛ أمَّا العجائز والأطفال فقد قُتلوا بلا رحمة للتخلص من عبء رعايتهم والعناية بهم.
فوجئ “ينماخو” بما حدث، وكان منشغلًا بمطاردة “نسحو” ورفاقه، فاستدعى القادة والمستشارين والكهنة، فوبخ “نسرو”، قائد الجيش،لأن جنوده لم يكونوا متواجدين حين تمت الغارة على الحدود الجنوبية؛ لكنه ردَّ عليه بأن الجيش كان منهارًا بعد الثورة، وأغلب القادة تمت تصفيتهم لمجرد الشك في ولائهم.
لم يكن لملك مثل “ينماخو” أن يتقبل الهزيمة بسهولة، عز عليه أن يبدوَ ضعيفًا مستسلمًا؛ فأصدر أوامره بأن يعيد قواده بناء الجيش، وأن يضموا إليه كل الشباب والمراهقين، كما أمر بأن يتوزع الكهنة في كل البلاد لينشروا بين الناس أن كل من يُقتَلُ في الحرب سوف يدخل العالمَ العلوي، ملِكًا يخدمه آلاف من العبيد والجواري، وأن من يهرب من الحرب فمصيره الشقاء والعذاب في العالم السفلي.
وليس أسهل من أن تقنع السذج والجهلة بالوعود الخادعة والأماني الكِذاب، فامتلأت نفوس الناريين حماسة لاسترداد قراهم المحتلة، واضطرمت قلوبهم بالشوق إلى نعيم العالم العلوي، فاندفعوا نحو عدوهم غير مبالين ولا هيابين، وأمدهم القائد “مونشي”، رغم حقده على “نسرو”، بحملة ثانية، أستطاع أن يقلب بها كفة المعركة، فتقهقر جيش بابل، ولاحقهم الناريون من الخلف، ولم يتمكنوا من الفرار عبر النهر، فاصطبغت مياهه بدماء الغارقين فيه، وارتفعت رايات النصر، وعاد رسول القائد “نسرو” ليبشر “ينماخو” بالحدث العظيم، لكنه كان مخمورًا بنشوة تغلبه على جلجامش، وأخذه الغرور إلى أبعد مداه، فأمر الرسول أن يرجع إلى “نسرو” ليخبره بأنه لم ينتصر بعد، وعليه أن يبقى هو وقواته في الجنوب؛ فالنصر الحقيقي هو يوم سقوط بابل.
لم يكن “ينماخو” قائدًا ولا محاربًا، ولم يكن يقدر عواقب أوامره، كان كل همه أن يغزو بابل ويضمها إلى ملكه، أما قادة جيشه فكان لهم رأيٌ آخر؛ فهم يدركون جيِّدًا أن ناريَّا منهكةٌ بسبب الثورة، ومعركة التحرير الجنوبية، وأن الجنود غير مستعدين ولا مؤهلين لعبور النهر وغزو بابل. غير أنهم لم يكونوا يملكون حق الرفض، ولا حق المعارضة، ورغم أنهم يعرفون المصاعب التي سيواجهونها، وأن غزوًا كهذا سوف يكبدهم خسائر فادحة من الأروح والعُدد، لم يكن أمامهم سوى أن ينفذوا تعليمات الملك بلا تردد، إلى درجة أنهم لم يجرؤوا على أن يطلبوا منه نجدةً أو مددًا.
وعلى الجانب الآخر كان البابليون يعدون للأمر عدته، وكان القائد “أوروك” يبث الحمية في نفوس جنوده، ويأمرهم ألا يتركوا واحدًا من الناريين يعبر الخنادق، وأن يواجهوهم بكل قوة، وأن يمطروهم بالسهام فور نزولهم من التلال التي يتحصنون خلفها، وأن يحرقوهم في الخنادق ليشم رائحة الشواء في جميع الأنحاء.
لم تكن المعركةُ سهلةً في هذه المرَّة؛ صحيح أن الناريين أعادوا بناء جيشهم في فترة وجيزة، وانضم إليه آلاف من الشباب الذين ملأتهم الحماسة بفعل كلمات الكهنة ووعودهم بالنعيم الأبدي في العالم العلوي، لكن هذا نفسه كان سبب هزيمتهم للمرة الثانية؛ فالعجلة لا تصنع جيشًا قادرًا على خوض معركة ضارية مع منافس شرس؛ والقادة قلة، والجنود غير مدربين تدريبًا كافيًا، وقد دفع بهم “ينماخو” إلى أتون الحرب من أجل أن يقال إنه لم يرفع الراية البيضاء لخَصمه اللدود. وكانت الهزيمة مريرةً قاسية؛ ذهب ضحيتها آلاف الناريين الذين غرر بهم “ينماخو”، وقدمهم صيدًا سهلًا لجنود بابل المتعطشين لدمائهم.
كان “جلجامش” في المعسكر يشرف على تدريب جنوده، حين بلغته أنباء الهزيمة الساحقة التي مُنِي بها الناريون، وكان “ينماخو” في قصره ينتظر الرسول الذي يخبره بمصارع البابليين، فلما جاءه الرسول بما خيَّب آماله وخالف توقعاته، لم يفطن إلى خطأ توجيهاته، ولم يعترف بذنبه في حق آلاف القتلى من مواطنيه، بل أمره مرةً أخرى أن يعود إلى نسرو ويبلغه ألا يعود، وأن يبقى في الجنوب، وأنه سوف يمده بالجنود والحرفيين الذين يصنعون العَبَّارات والمراكب لعبور النهر، وقال لمن حوله في غرورٍ سكران: إننا لن نستسلمَ أبدًا، وسوف نسعى بكل قوتنا لعبور النهر، حتى نصلَ إلى أسوار بابلَ وندكَّها دكًّا، ونقبض على “جلجامش” ونعدمه في ساحة المعبد في ناريَّا. هكذا صورت له أوهامُه، وهكذا اغتر بنفسه وصدق أكاذيبه، وهو ما كان له ثمنه الفظيع على أرض الواقع.
لقد نصَبَ البابليون للناريين فخًّا شيطانيًّا؛ لم يكونوا يتخيلونه ولا يقدرون على النجاة منه؛ فقد تركوهم يعبرون النهر وينزلون على اليابسة، وكانوا قد فرشوا الأرضَ بالقش، وصبُّوا عليها القار، ولم تكد أقدامهم تطؤها حتى تحولت إلى جحيم حارقة من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ثم أرشقوهم بالنبال المشتعلة من كل حدب وصوب، وانتشرت رائحة جثثهم المحترقة في انحاء بابل. وخسرت ناريَّا آلافًا أخرى من أبنائها، وقدمتهم مرغمةً قربانًا رخيصًا في معبد “دموزي” العظيم !
ولم يتعلم “ينماخو” الدرس، ولم يتعظ بالحوادث؛ فالطغاة متبلدو الفهم بقدر ما هم متبلدو العواطف، واستبد به الجنون المتغطرس وأمر بان يحاول جنوده مرةً بعد مرة، حتى يتمكنوا من دخول بابل وهدم ما فيها على من فيها. وقد كان يمكن أن يكون هذا الموقف صمودًا يحسب لصاحبه، لولا أنه كان قرارًا طائشًا بلا عقل ولا رويَّة، وقد تكررت المأساة بصورة فاجعة ودموية؛ ففلمرة الثانية ترك البابليون جنود ناريَّا يبنون جسرًا من الحجارة ليعبروا عليه إلى بابل، وما إن اقتربت قواتهم من الشاطئ حتى هاجت أمواج النهر الذي كان البابليون قد جففوه ليخدعوا الناريين، وتحولت إلى طوفان جارفٍ، فغرق من غرق، وقُتل من قُتل، وأبيد جيش ناريَّا للمرة الثالثة.
انهزم “ينماخو” في كل معركة خاضها، ولم يستطع أن يؤمِّن حدود بلاده كما زعم، ولم ينجح في أن يقنع شعبه بأن حروبه كانت لخدمة بلادهم وحمايتها من الأعدءالمترصين بها، ولمَّا هُزم في الخارج أراد أن يحفظ ماء وجهه بمحاولة تحقيق نصر في الداخل، ولم يكن أمامه سوى أن يفتش عن “نسحو” ومن فرَّ وراءه من تلاميذ والده “إيليم” ومحبي حكمته. ولم يكن “نسحو” بعيدًا عما يحدث في بلاده، ولم يشغله طلب الحكمة عن متابعة أخبار أبناء وطنه؛ ورغم أنه كان مغضوبًا عليه من “ينماخو” وزبانيته إلا أنه كان يتابع ما يجري، فيحزن لهزيمة الناريين، ويفرح لانتصارهم؛ ويعز عليه ألا يكون جنديًّا في ميدان المعركة ليدافع عن وطنه ويفتديه بروحه.
أمَّا “ينماخو” ومن حوله فلم يكونوا ليتركوا “نسحو” ينعم بالحياة بعد أن تسلل بعض رفاقه إلى ناريَّا وأخذوا ينشرون دعوته ويعلمون الشباب حكمة والده. فتمكن البصاصون والجواسيس من القبض على صاحبه “داليم” وإعدامه هو وبعض رفاقه، رغم أنه جاء ليعلم الناريين أن يواجهوا “ينماخو” بنور الحكمة، وألا يلجأوا إلى الدم في محاربة الظلم، وأن يكون سلاحهم الرفض والعصيان والاحتجاج السلمي، لا بالقتل وسفك الدماء الي لن يجلب لهم الحرية، بل سيأتي لهم من بعده بمن هو أكثر ظلمًا وتجبُّرًا من دولة الكهنة.
ولم يكن صعبًا على مخابرات “ينماخو” أن تعرف مكان “نسحو”، وأنه اتخذ من بيت الحكيم “جانو” دارًا لتعليم الحكمة، فأرسلوا وفدًا إلى ملك “بيبلوس”، يحمل له الهدايا في يد، ويحمل في اليد الأخرى تهديدًا بقطع ما يصدرونه لبلاده من التمور إن لم يسلمهم “نسحو” ومن معه؛ وكان رفض الملك قاطعًا، وتوسط “جامو” الحكيم لدى الملك وعرض عليه حلًّا وسطًا، وهو أن يسمح لابن أخته أن يغادر المدينة إلى أي مكانٍ آخر، وكانت قبائل خاله الشمالية هي ذلك المكان.
وكان قد سبقه إلى ناريَّا جماعةٌ من رفاقه الذين تعلموا على يديه، استطاعوا بحيلة بارعة أن يتسللوا إلى ناريَّا ومعهم الصحف التي دونوا فيها “حكمة نسحو وتعاليم إيليم”، واستطاعوا أن يستنسخوها ويوزعوها على الشباب الذي كان يتوق إلى ما يعوضه عن الشعور بهوان الهزيمة وذلة الانكسار، وكما يقول الكاتب بنص كلامه؛ فقد “نجح (نسحو) بالتأثير على شعبه وهو بعيدٌ في بلاد الغربة، بالحكمة أحيا ناريَّا الميتة، بالحكمة أشعل النور في النفوس المظلمة، بالحكمة أعاد النبضَ إلى قلوب شعب ناريَّا، أصبحوا أكثر وعيًا ورفضًا لحكم الكهنة، وأخذوا يقولون في تجمعاتهم السرية: لِيعُد الكهنة إلى معابدهم، ويتركوا السلطة للشعب”.
أحس “نسحو” بانه قد صنع لبلاده شيئًا، وإن لم يكن قد أتم رسالته بعد، وأراد أن يستريح قليلًا بعيدًا عن بطش “ينماخو” ومكايد مستشاريه، فتوجه إلى قبيلة خاله لينعم بشيء من الراحة والطمأنينة، وليتزوج من “ميرا”، حبيبة قلبه التي كانت تنتظر عودته على أحر من الجمر، لكن “نسرو” المهزوم في المعارك كان له بالمرصاد، وتمكن من القيض عليه والعودة به إلى ناريَّا مكبلًا بالسلاسل والأغلال هو و”ميرا” ومن كان معه من رفاقه.
وفي ساحة المعبد الأكبر، تجمع شعب ناريَّا، ليشهد مصرع الحكمة مرةً أخرى، حيث تم إعدام “نسحو”، وبالتفاصيل نفسها التي جرت يوم صُلِب أبوه الحكيم “إيليم”، مع فارقٍ جوهريٍّ واحد؛ أنهى به الكاتب روايته المثيرة: ” فجأةً ظهر من بين الحشود “لامو” ـ رفيق نسحو وتلميذه ـ وتوجه بنظره إلى صديقه المصلوب، ولم يتمالك نفسه، فأخذ يهتف بأعلى صوته ويقول: “الموت لينماخو، ويسقط حكم الكهنة”. وأخذت الحشود الحاضرة تردد خلفه بصوتٍ عالٍ: “الموت لينماخو، ويسقط حكم الكهنة”. هجم عليهم الحرس الكهنوتيُّ، وأخذوا يحاولون تفريقهم وإبعادهم عن ساحة المعبد، ولكن ثبتوا في مواقعهم، وقاوموا الحرس، واستمرُّوا يرددون بشجاعة: “الموت لينماخو، ويسقط حكم الكهنة”.
● إطلالةٌ على بناء الرواية وفكرتها:
لم يحدث أبدًا أن قرأت روايةً واحدةً خمسَ مراتٍ متتاليات، وفي يومين اثنين متتابعين، إلا روايةَ ( نارِيَّا )، للأديب حسن علي أنواري، لا لأنني لم أفهم فكرتها أو لم أستوعب أحداثها؛ بل لأنني كنت مستمتعًا بأسلوبها السلس المتدفق، ولغتها السهلة المؤنسة، وحبكتها الفنية المُحكَمَة. إنها فانتازيا تاريخية أسطورية، بَيْدَ أنها لا تنفصل عن الواقع ولا تتهرب منه، كما أنها شبه خيالية في حوادثها وشخصياتها، لكنها توشك أن تكون حقيقية فيما ترمز إليه وما توحي به.
يمكننا القولُ بأنها روايةُ إسقاطٍ سياسيٍّ بامتياز؛ لم يجعلها صاحبُها وصفًا مباشرًا للأحداث الجارية، أو تقريرًا دراميًّا بما يدور في عالمنا العربي، ولو فعل لفقدت الرواية شيئًا كبيرًا من قيمتها الفنية. وسوف نظلم هذه الرواية كثيرًا إذا قلنا إنها تعالج ما يدور في منطقتنا فحسب؛ لأنها تتجاوز هذا إلى ما هو أبعد مدى وأوسع دائرة. إنها عالمية بقدر ما يمكن أن تكون إقليمية، وإنسانية بقدر ما يمكن أن تكون محلية.
تتكون الرواية من مقدمة وخاتمة وبينهما خمسة وعشرون فصلًا قصيرًا، حملت المقدمة عنوانًا مقصودًا هو “أفول شمس الحكمة”، وجاءت الخاتمة تحت عنوان مقصودٍ آخر هو “بزوغ فجر جديد”، أما الفصول فلم تحمل عناوينَ بل أرقامًا. وتتوزع أحداثها من حيث المكان بين ناريَّا وبيبلوس وجلجامش، ولا تستغرق من الزمان أكثر من عامين، هما اللذان يفصلان بين المقدمة والخاتمة. وقد لجأ المؤلف إلى تقنية المونتاج السينمائي في عرض حوادث روايته، ففصلٌ في ناريَّا، وبعده آخر في جلجامش، ويليهما ثالُ في بيبلوس، وهكذا دواليك في الرواية كلها، يفعل ذلك بصورة تلقائية بسيطة، فلا تداخل في الحوادث ولا تعقيد في التفاصيل، وهو ما يدفع الملل عن القارئ ويجذبه إلى قراءة الرواية من ألفها إلى يائها دون ضجر أو رهَق.
ولا أخفي أنني كنت مشدودًا إلى متابعة أحداثها بلهفةٍ شديدة وفضولٍ غريب، وكان وراء هذا أسلوب الكاتب الشائق ولغته التلغرافية. ولكنني لم أكد أصل إلى الخاتمة حتى سألت نفسي: أين الرواية في كل ما قرأت؟ وأين فكرتها ومغزاها؟ هل ضيعت وقتي بمطالعة أكثر من مائة وثمانين صفحة ليخبرني الكاتب إن الرواية قد انتهت بما بدأت به، وأن لا فائدة من مقاومة الظلم بالحكمة، ولاجدوى من مواجهة الطغيان بالعصيان المدني والاحتجاج السلمي؟! وتمهلت قليلًا قبل أن أصدر هذا الحكم، حتى قرأت السطور الأخيرة التي أثبتها منذ قليل، والتي ذكر فيها المؤلف أن جهاد “نسحو” لم يذهب سُدى، وأن حياته لم تضع هباءً، وأن ما قدمه هو ورفاقه من تضحيات ليكشفوا الحقيقة لأبناء شعبهم لم يكن شيئًا هيِّنًا. لقد فضحوا حكم الكهنة المستبدين، الذين يخدعون الجماهير بطقوس خرافية، ويجعلون من الكاهن ظلَّ الإله في الأرض، فيبطش بمن يشاء كما يشاء.
ثمة بعض الأسئلة عن فكرة هذه الرواية ومغزاها: هل يمكن للحكمة وحدها أن تواجه الظلم وتقضي على دولته؟ هل يمكن للشعوب إذا ما تعلمت الحكمة أن تقف في وجه القوة وتقاومها؟ ثم لماذا لم يحدثنا الكاتب عن العلم، وهو يختلف عن الحكمة كما نعرف؟ لماذا لم يجعل منه سلاحًا آخر يتسلح به الناس في مواجهة سلطان الخرافة والأساطير وهيمنة المتجبرين والمتغطرسين؟ ولعل إجابة هذه الأسئلة تحملها لنا السنوات القادمة التي قد يكون فيها مصير هذا العالم الذي يغلب عليه الطيش والرعونة والحماقة، ويفتقد من يذكره بصوت العقل ونداء الحكمة.
وللكاتب خالص تحياتي، وأملي وهو يخطو نحو الخمسين من عمره، أن يقدم لنا أعمالًا روائيةً أخرى، وأظنه سيفعل، لأن مطالعاته وأفكاره يمكن أن تجد طريقها إلى القراء من خلال سرده الرائق وأسلوبه الجميل.
أدركت فيما بعد أن قَطَرَ قد تأخرت كثيرًا في إبداع الرواية، وأنها كانت استثناءً نادرًا حين بدأ مبدعوها بكتابة القصة القصيرة، على خلاف ما هو سائدٌ في كل بلاد العالم حيث تسبق الروايةُ القصة في الظهور والانتشار. وكانت البداية نسويةً خالصة؛ حيث اشتركت الروائيتان القطريتان شعاع خليفة ودلال خليفة في وضع أول لبنة في الصرح الروائي القطري؛ فأصدرت شعاع روايتها الأولى “العبور إلى الحقيقة” سنة 1993، ثم أتبعتها في العام نفسه بروايتها الثانية “أحلام البحر القديمة”، وجاءت بعدها دلال خليفة لتخرج على القراء برواية “أسطورة الإنسان والبحيرة”، ثم رواية “أشجار البراري البعيدة” سنة 1994، ثم أخرجت روايتها الثالثة “من البحَّار القديم إليك” سنة 1995، وكان علينا أن ننتظر خمس سنواتٍ حتى تصدر روايتها الرابعة “دنيانا: مهرجان الأيام والليالي”.
وبعد هذه الروايات القطرية الست، بدأ فن الرواية ينتشر في صفوف الكتاب القطريين، فأصدر أحمد عبد الله روايته الأولى “أحضان المنافي” في عام 2005، و”القنبلة” في عام 2006، و”فازع شهيد الإصلاح في الخليج” في عام 2010، و”الأقنعة” في عام 2011، ثم بدأت خريطة الرواية القطرية تتسع أكثر، فأصدرت مريم آل سعد في عام 2007 روايتها الأولى “تداعي الفصول”، ثم أصدرت نورة آل سعد عام 2010 روايتها الأولى “العريضة”، وفي عام 2011 أصدر عبد العزيز آل محمود روايته “القرصان”.
أما في عام 2014، فأصدر الروائي جمال فايز روايته الأولى “زبد الطين“، وفي عام 2013 أصدر عبد الله عيسى روايته الأولى “كنز سازيران”، ثم أصدر في عام 2014 روايته الثانية “كنز سازيران.. بوابة كتارا وألغاز دلمون”، كما أصدر في عام 2015 روايته الثالثة “شوك الكوادي”، وهكذا توالت الروايات القطرية فأصدرت شمة شاهين الكواري في عام 2014 روايتها الأولى “نوافير الغروب”، ثم أصدرت الكاتبة أمل السويدي روايتها “الشقيقة”.
ولست هنا لأعرض تاريخ الرواية في قطر، لا إيجازًا ولا تفصيلًا، ففي كتاب “الرواية القطرية: قراءة في الاتجاهات” للدكتور أحمد عبد الملك، ما يرضي الراغب ويُقنع المستزيد؛ وإن كان قد توقف بدراسته عند حدود سنة 2014. ولكنني أريد أن أتبين موقع “ناريًّا” في خريطة الإبداع القطري، وأضع يد القارئ على قيمتها: ريادةً وفنًّا. ومكانة صاحبها في عالم الإبداع الروائي في بلاده.
ولعل القاري يندهش حين يعرف أن “ناريَّا” هي العمل الروائي الأول للأستاذ حسن علي أنواري، وهذا ما يغفر له أكثر ما يمكن أن يؤخذ عليه، وسوف يشتد عجبه حين يفرغ من قراءتها والمتعة بها. صحيح أن كاتبها واحدٌ من المثقفين الكبار في وطنه، وأنه يشتغل في عالم الكتب والمكتبات والإعلام، وأن له كتابًا متميزًا سمَّاه “رائحة الكتب: سيرة ذاتية بعبق القراءة”، وسوف أعود إليه بعد قليل، ولكن هذا لا يكفي ليخلق منه كاتبًا روائيًّا متمكنًا؛ إلا إذا كان موهوبًا في الحكي الشائق والسرد الجذاب، وهو ما أثبته بقوة في باكورة رواياته.
لا أدري على وجه التحديد كيف اختمرت هذه الرواية في ذهن صاحبها خاطرًا فخاطرًا، ولا كيف اكتملت تفاصيلُها على الورق فصلًا بعد فصل، ولكنني أزعم أن فكرتها راودته منذ فترة بعيدة، وأن الأحداث التي تدور من حوله هي التي دفعته دفعًا إلى كتابتها. أمَّا فكرتُها وشكلها فربما يرجعان إلى قراءاته المتأنية في التاريخ القديم، وربما نرجِّح هذا حين نعلمُ أنه قد خصص في الفصل الثالث من كتابه “رائحة الكتب” عن قصة نشأة الكتابة عبر «ألواح سومر»، التي وصفها عالم الحضارة السومرية «صمويل كريمر» بأنها إنجازٌ كبير ومذهل لعلوم القرن التاسع عشر وللإنسانية»، لتكون المفتاح الذي ينقل للأجيال المعارف والعلوم. فأحداثها تدور في العراق وما حوله مكانًا، وقبل ميلاد المسيح بما يقرب من ثمانية وعشرين قرنًا من عمر الزمان. يدلنا على ذلك شخصية “جلجامش” وهو أحد أبطالها، و”بابل” و بيبلوس” وهما من أهم الأماكن فيها.
● عرضٌ موجَزٌ لأحداث الرواية:
تبدأ الرواية بمشهدٍ غير إنساني، تتبدَّى فيه وحشية حاكمٍ ظالم ومستبد، يُدعَى “ينماخو”، لا تعرف الرحمة طريقًا إلى قلبه القاسي، ولا يتبين العدل سبيلًا إلى عقله المظلم. لا يسمح لأحدٍ أن يعارضه، ولا يُجيزُ لمخلوقٍ أن يناقشه. لقد كان من قبلُ كاهنًا يدَّعي محبة الناس، ولكنه انقلب على حاكمه بثورة دموية، تحول من بعدها إلى متجبر طاغية، وكما يقول المؤلف، فإن الكهنة عندما يكونون في المعبد يكونون في غاية الرحمة والرقة، ولكن ما إن يمسكوا بصولجان الحُكم فإنهم يتحولون إلى مجرمين.
ولم تكد الأمور تستقر له حتى أمر بإعدام كل من يعارضون حكمه ولا يعترفون له بأنه ظل الإله “دموزي” في الأرض. وكان الحكيم “إيليم” أكثر هؤلاء الخارجين عليه شُهرةً وأعلاهم صوتًا وأقواهم تأثيرًا، فأصدر تعليماته بصلبه في ساحة المعبد الأكبر، فدفعوا به وهو مثقلٌ بالقيود والأغلال التي وضعت في عنقه ورجليه، وهناك رفعوه إلى الصليب، وسملوا عينيه، وثبتوه بمسامير دُقَّت في كفيه وقدميه، وبسلاسل طوقت خصره ورقبته. ولما رفض أن يستجيب لهم ويتراجع عن موقفه، أشار الملك إلى قائد الحرس الكهنوتي فسحب لسان “إيليم” بكماشة وقطعه بسكين، وأخرج قلبَه من صدره. ساعتها نظر إليه أحد تلاميذه وهو يقول باكيًا: ” لقد غربت شمس الحكمة عن أرض ناريَّا، وغاب ضوء النهار، ولم تبقَ سوى الظُّلمة”.
لكن شمس الحكمة لا تغرب، وضوء النهار يغيب، والظلمة وإن طالت فسوف تزول؛ صحيح أن الملك “ينماخو” أمر بإعدام القادة الخارجين عليه، والحكماء الذين لا يعترفون به ملكًا، كما أمر بملاحقة الفارين منهم حتى لا يتمكنوا من بث روح الثورة عليه في أي مكان؛ لكن الأقدار اختارت “نسحو”، ابن الحكيم “إيليم”، ليكون خليفة أبيه ووارث حكمته، وهيأت له الأسباب لينشر مبادئه وتعاليمه، وليكون سببًا قويًّا في إشاعة الخوف والرعب في نفس “يمناخو” وأتباعه. إن الملوك إذا حكموا قريةً أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وقد يخيفون الناس بقوة السلاح الباطشة، فيطيعونهم مرغَمين، ويهتفون باسمهم مجبَرين؛ لكنهم لا يستطيعون أن يكتموا صوت ضمائرهم، ولا يقدرون على قتل كلمة الحق التي تثور في نفوسهم.
استطاع “نسحو” أن يفرَّ بأعجوبةٍ إلى بلاد الشمال، موطن قبائل أخواله، ويقيم هناك ضيفًا معزَّزَا مكرَّمًا على خاله ، الذي يهيئ له الأسباب ليلتقي برفاقه وتلاميذه ليعلمهم حكمة أبيه. ثم لم يلبث أن انتقل إلى مدينة “بيبلوس” الفينيقية ـ جبيل اللبنانية الآن ـ وهي واحدةٌ من أقدم المدن المسكونة في العالم، تختلف عن “ناريَّا” اختلافًا كبيرًا؛ فلا معارك ولا صراعات سياسية، وإنما سعيٌ وراء التجارة التي لا تزدهر إلا بالسلام بين مختلِف المدن الفينيقية، ومتعة بالرفاهية التي جعلت الناس يقبلون على تعلم الحكمة ويرفعون من شأن الحكماء.
وهناك تعلم “نسحو” الدرس الأكبر الذي تمنى أن ينقله لمواطنيه في “ناريَّا”، وهو الرقي والانفتاح على الآخر، وتقبل الآراء المختلفة؛ فهذا ما يفتقر إليه الناريون المتعصبون والمنغلقون على أنفسهم. هناك أيضًا رأى ما أدهشه وأثار إعجابه، فملك “بيبلوس” قد جعل إلى جوار قصره دارًا لتلقي مظالم المواطنين، خصصها ليضمن للشعب حقوقه، حتى لا يتعرض أحد أفراده للظلم.
وفي الوقت الذي كان “سحنو” ورفاقه يتعلمون الحكمة ويطلبونها أين وجدوها، كانت الأمور تمضي على نحوٍ آخر تمامًا في “ناريَّا”. كان “ينماخو” قد فقد أكثر قواد جيشه، وأعظم حكماء مملكته، فصار بلا قوةٍ ولا عقل، وجعله هذا مطمعًا لأعدائه، فانتهز “جلجامش”، ملك بابل، هذه الفرصة وأمر قواده أن يغتنموها ليستولوا على النهر الشمالي والقرى الزراعية حوله، وقد كان هو الآخر حاكمًا مستبدًّا، وصل إلى سُدة الحكم بعد أن انقلب على صديقه الطيب العادل “أنكيدو”، وأعلن عبادة مردوخ، ولم يكن أحدٌ من قادته أو مستشاريه يجرؤ على معارضته، وكلهم يعلمون أن الموت المحقَّق هو مصير من ينبس في مجلسه ببنت شفةٍ ليعارض أو يجادل.
واستطاعت قوات “جلجامش” أن تغير على القرى الجنوبية في ناريَّا، فباغتها القائد “أوروك” وجنوده في جنح الليل، وانقضوا على أهلها كالذئاب الجائعة، فذبحوا الرجال ذبح الخراف، وساقوا النساء سبايا ذليلات؛ أمَّا العجائز والأطفال فقد قُتلوا بلا رحمة للتخلص من عبء رعايتهم والعناية بهم.
فوجئ “ينماخو” بما حدث، وكان منشغلًا بمطاردة “نسحو” ورفاقه، فاستدعى القادة والمستشارين والكهنة، فوبخ “نسرو”، قائد الجيش،لأن جنوده لم يكونوا متواجدين حين تمت الغارة على الحدود الجنوبية؛ لكنه ردَّ عليه بأن الجيش كان منهارًا بعد الثورة، وأغلب القادة تمت تصفيتهم لمجرد الشك في ولائهم.
لم يكن لملك مثل “ينماخو” أن يتقبل الهزيمة بسهولة، عز عليه أن يبدوَ ضعيفًا مستسلمًا؛ فأصدر أوامره بأن يعيد قواده بناء الجيش، وأن يضموا إليه كل الشباب والمراهقين، كما أمر بأن يتوزع الكهنة في كل البلاد لينشروا بين الناس أن كل من يُقتَلُ في الحرب سوف يدخل العالمَ العلوي، ملِكًا يخدمه آلاف من العبيد والجواري، وأن من يهرب من الحرب فمصيره الشقاء والعذاب في العالم السفلي.
وليس أسهل من أن تقنع السذج والجهلة بالوعود الخادعة والأماني الكِذاب، فامتلأت نفوس الناريين حماسة لاسترداد قراهم المحتلة، واضطرمت قلوبهم بالشوق إلى نعيم العالم العلوي، فاندفعوا نحو عدوهم غير مبالين ولا هيابين، وأمدهم القائد “مونشي”، رغم حقده على “نسرو”، بحملة ثانية، أستطاع أن يقلب بها كفة المعركة، فتقهقر جيش بابل، ولاحقهم الناريون من الخلف، ولم يتمكنوا من الفرار عبر النهر، فاصطبغت مياهه بدماء الغارقين فيه، وارتفعت رايات النصر، وعاد رسول القائد “نسرو” ليبشر “ينماخو” بالحدث العظيم، لكنه كان مخمورًا بنشوة تغلبه على جلجامش، وأخذه الغرور إلى أبعد مداه، فأمر الرسول أن يرجع إلى “نسرو” ليخبره بأنه لم ينتصر بعد، وعليه أن يبقى هو وقواته في الجنوب؛ فالنصر الحقيقي هو يوم سقوط بابل.
لم يكن “ينماخو” قائدًا ولا محاربًا، ولم يكن يقدر عواقب أوامره، كان كل همه أن يغزو بابل ويضمها إلى ملكه، أما قادة جيشه فكان لهم رأيٌ آخر؛ فهم يدركون جيِّدًا أن ناريَّا منهكةٌ بسبب الثورة، ومعركة التحرير الجنوبية، وأن الجنود غير مستعدين ولا مؤهلين لعبور النهر وغزو بابل. غير أنهم لم يكونوا يملكون حق الرفض، ولا حق المعارضة، ورغم أنهم يعرفون المصاعب التي سيواجهونها، وأن غزوًا كهذا سوف يكبدهم خسائر فادحة من الأروح والعُدد، لم يكن أمامهم سوى أن ينفذوا تعليمات الملك بلا تردد، إلى درجة أنهم لم يجرؤوا على أن يطلبوا منه نجدةً أو مددًا.
وعلى الجانب الآخر كان البابليون يعدون للأمر عدته، وكان القائد “أوروك” يبث الحمية في نفوس جنوده، ويأمرهم ألا يتركوا واحدًا من الناريين يعبر الخنادق، وأن يواجهوهم بكل قوة، وأن يمطروهم بالسهام فور نزولهم من التلال التي يتحصنون خلفها، وأن يحرقوهم في الخنادق ليشم رائحة الشواء في جميع الأنحاء.
لم تكن المعركةُ سهلةً في هذه المرَّة؛ صحيح أن الناريين أعادوا بناء جيشهم في فترة وجيزة، وانضم إليه آلاف من الشباب الذين ملأتهم الحماسة بفعل كلمات الكهنة ووعودهم بالنعيم الأبدي في العالم العلوي، لكن هذا نفسه كان سبب هزيمتهم للمرة الثانية؛ فالعجلة لا تصنع جيشًا قادرًا على خوض معركة ضارية مع منافس شرس؛ والقادة قلة، والجنود غير مدربين تدريبًا كافيًا، وقد دفع بهم “ينماخو” إلى أتون الحرب من أجل أن يقال إنه لم يرفع الراية البيضاء لخَصمه اللدود. وكانت الهزيمة مريرةً قاسية؛ ذهب ضحيتها آلاف الناريين الذين غرر بهم “ينماخو”، وقدمهم صيدًا سهلًا لجنود بابل المتعطشين لدمائهم.
كان “جلجامش” في المعسكر يشرف على تدريب جنوده، حين بلغته أنباء الهزيمة الساحقة التي مُنِي بها الناريون، وكان “ينماخو” في قصره ينتظر الرسول الذي يخبره بمصارع البابليين، فلما جاءه الرسول بما خيَّب آماله وخالف توقعاته، لم يفطن إلى خطأ توجيهاته، ولم يعترف بذنبه في حق آلاف القتلى من مواطنيه، بل أمره مرةً أخرى أن يعود إلى نسرو ويبلغه ألا يعود، وأن يبقى في الجنوب، وأنه سوف يمده بالجنود والحرفيين الذين يصنعون العَبَّارات والمراكب لعبور النهر، وقال لمن حوله في غرورٍ سكران: إننا لن نستسلمَ أبدًا، وسوف نسعى بكل قوتنا لعبور النهر، حتى نصلَ إلى أسوار بابلَ وندكَّها دكًّا، ونقبض على “جلجامش” ونعدمه في ساحة المعبد في ناريَّا. هكذا صورت له أوهامُه، وهكذا اغتر بنفسه وصدق أكاذيبه، وهو ما كان له ثمنه الفظيع على أرض الواقع.
لقد نصَبَ البابليون للناريين فخًّا شيطانيًّا؛ لم يكونوا يتخيلونه ولا يقدرون على النجاة منه؛ فقد تركوهم يعبرون النهر وينزلون على اليابسة، وكانوا قد فرشوا الأرضَ بالقش، وصبُّوا عليها القار، ولم تكد أقدامهم تطؤها حتى تحولت إلى جحيم حارقة من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ثم أرشقوهم بالنبال المشتعلة من كل حدب وصوب، وانتشرت رائحة جثثهم المحترقة في انحاء بابل. وخسرت ناريَّا آلافًا أخرى من أبنائها، وقدمتهم مرغمةً قربانًا رخيصًا في معبد “دموزي” العظيم !
ولم يتعلم “ينماخو” الدرس، ولم يتعظ بالحوادث؛ فالطغاة متبلدو الفهم بقدر ما هم متبلدو العواطف، واستبد به الجنون المتغطرس وأمر بان يحاول جنوده مرةً بعد مرة، حتى يتمكنوا من دخول بابل وهدم ما فيها على من فيها. وقد كان يمكن أن يكون هذا الموقف صمودًا يحسب لصاحبه، لولا أنه كان قرارًا طائشًا بلا عقل ولا رويَّة، وقد تكررت المأساة بصورة فاجعة ودموية؛ ففلمرة الثانية ترك البابليون جنود ناريَّا يبنون جسرًا من الحجارة ليعبروا عليه إلى بابل، وما إن اقتربت قواتهم من الشاطئ حتى هاجت أمواج النهر الذي كان البابليون قد جففوه ليخدعوا الناريين، وتحولت إلى طوفان جارفٍ، فغرق من غرق، وقُتل من قُتل، وأبيد جيش ناريَّا للمرة الثالثة.
انهزم “ينماخو” في كل معركة خاضها، ولم يستطع أن يؤمِّن حدود بلاده كما زعم، ولم ينجح في أن يقنع شعبه بأن حروبه كانت لخدمة بلادهم وحمايتها من الأعدءالمترصين بها، ولمَّا هُزم في الخارج أراد أن يحفظ ماء وجهه بمحاولة تحقيق نصر في الداخل، ولم يكن أمامه سوى أن يفتش عن “نسحو” ومن فرَّ وراءه من تلاميذ والده “إيليم” ومحبي حكمته. ولم يكن “نسحو” بعيدًا عما يحدث في بلاده، ولم يشغله طلب الحكمة عن متابعة أخبار أبناء وطنه؛ ورغم أنه كان مغضوبًا عليه من “ينماخو” وزبانيته إلا أنه كان يتابع ما يجري، فيحزن لهزيمة الناريين، ويفرح لانتصارهم؛ ويعز عليه ألا يكون جنديًّا في ميدان المعركة ليدافع عن وطنه ويفتديه بروحه.
أمَّا “ينماخو” ومن حوله فلم يكونوا ليتركوا “نسحو” ينعم بالحياة بعد أن تسلل بعض رفاقه إلى ناريَّا وأخذوا ينشرون دعوته ويعلمون الشباب حكمة والده. فتمكن البصاصون والجواسيس من القبض على صاحبه “داليم” وإعدامه هو وبعض رفاقه، رغم أنه جاء ليعلم الناريين أن يواجهوا “ينماخو” بنور الحكمة، وألا يلجأوا إلى الدم في محاربة الظلم، وأن يكون سلاحهم الرفض والعصيان والاحتجاج السلمي، لا بالقتل وسفك الدماء الي لن يجلب لهم الحرية، بل سيأتي لهم من بعده بمن هو أكثر ظلمًا وتجبُّرًا من دولة الكهنة.
ولم يكن صعبًا على مخابرات “ينماخو” أن تعرف مكان “نسحو”، وأنه اتخذ من بيت الحكيم “جانو” دارًا لتعليم الحكمة، فأرسلوا وفدًا إلى ملك “بيبلوس”، يحمل له الهدايا في يد، ويحمل في اليد الأخرى تهديدًا بقطع ما يصدرونه لبلاده من التمور إن لم يسلمهم “نسحو” ومن معه؛ وكان رفض الملك قاطعًا، وتوسط “جامو” الحكيم لدى الملك وعرض عليه حلًّا وسطًا، وهو أن يسمح لابن أخته أن يغادر المدينة إلى أي مكانٍ آخر، وكانت قبائل خاله الشمالية هي ذلك المكان.
وكان قد سبقه إلى ناريَّا جماعةٌ من رفاقه الذين تعلموا على يديه، استطاعوا بحيلة بارعة أن يتسللوا إلى ناريَّا ومعهم الصحف التي دونوا فيها “حكمة نسحو وتعاليم إيليم”، واستطاعوا أن يستنسخوها ويوزعوها على الشباب الذي كان يتوق إلى ما يعوضه عن الشعور بهوان الهزيمة وذلة الانكسار، وكما يقول الكاتب بنص كلامه؛ فقد “نجح (نسحو) بالتأثير على شعبه وهو بعيدٌ في بلاد الغربة، بالحكمة أحيا ناريَّا الميتة، بالحكمة أشعل النور في النفوس المظلمة، بالحكمة أعاد النبضَ إلى قلوب شعب ناريَّا، أصبحوا أكثر وعيًا ورفضًا لحكم الكهنة، وأخذوا يقولون في تجمعاتهم السرية: لِيعُد الكهنة إلى معابدهم، ويتركوا السلطة للشعب”.
أحس “نسحو” بانه قد صنع لبلاده شيئًا، وإن لم يكن قد أتم رسالته بعد، وأراد أن يستريح قليلًا بعيدًا عن بطش “ينماخو” ومكايد مستشاريه، فتوجه إلى قبيلة خاله لينعم بشيء من الراحة والطمأنينة، وليتزوج من “ميرا”، حبيبة قلبه التي كانت تنتظر عودته على أحر من الجمر، لكن “نسرو” المهزوم في المعارك كان له بالمرصاد، وتمكن من القيض عليه والعودة به إلى ناريَّا مكبلًا بالسلاسل والأغلال هو و”ميرا” ومن كان معه من رفاقه.
وفي ساحة المعبد الأكبر، تجمع شعب ناريَّا، ليشهد مصرع الحكمة مرةً أخرى، حيث تم إعدام “نسحو”، وبالتفاصيل نفسها التي جرت يوم صُلِب أبوه الحكيم “إيليم”، مع فارقٍ جوهريٍّ واحد؛ أنهى به الكاتب روايته المثيرة: ” فجأةً ظهر من بين الحشود “لامو” ـ رفيق نسحو وتلميذه ـ وتوجه بنظره إلى صديقه المصلوب، ولم يتمالك نفسه، فأخذ يهتف بأعلى صوته ويقول: “الموت لينماخو، ويسقط حكم الكهنة”. وأخذت الحشود الحاضرة تردد خلفه بصوتٍ عالٍ: “الموت لينماخو، ويسقط حكم الكهنة”. هجم عليهم الحرس الكهنوتيُّ، وأخذوا يحاولون تفريقهم وإبعادهم عن ساحة المعبد، ولكن ثبتوا في مواقعهم، وقاوموا الحرس، واستمرُّوا يرددون بشجاعة: “الموت لينماخو، ويسقط حكم الكهنة”.
● إطلالةٌ على بناء الرواية وفكرتها:
لم يحدث أبدًا أن قرأت روايةً واحدةً خمسَ مراتٍ متتاليات، وفي يومين اثنين متتابعين، إلا روايةَ ( نارِيَّا )، للأديب حسن علي أنواري، لا لأنني لم أفهم فكرتها أو لم أستوعب أحداثها؛ بل لأنني كنت مستمتعًا بأسلوبها السلس المتدفق، ولغتها السهلة المؤنسة، وحبكتها الفنية المُحكَمَة. إنها فانتازيا تاريخية أسطورية، بَيْدَ أنها لا تنفصل عن الواقع ولا تتهرب منه، كما أنها شبه خيالية في حوادثها وشخصياتها، لكنها توشك أن تكون حقيقية فيما ترمز إليه وما توحي به.
يمكننا القولُ بأنها روايةُ إسقاطٍ سياسيٍّ بامتياز؛ لم يجعلها صاحبُها وصفًا مباشرًا للأحداث الجارية، أو تقريرًا دراميًّا بما يدور في عالمنا العربي، ولو فعل لفقدت الرواية شيئًا كبيرًا من قيمتها الفنية. وسوف نظلم هذه الرواية كثيرًا إذا قلنا إنها تعالج ما يدور في منطقتنا فحسب؛ لأنها تتجاوز هذا إلى ما هو أبعد مدى وأوسع دائرة. إنها عالمية بقدر ما يمكن أن تكون إقليمية، وإنسانية بقدر ما يمكن أن تكون محلية.
تتكون الرواية من مقدمة وخاتمة وبينهما خمسة وعشرون فصلًا قصيرًا، حملت المقدمة عنوانًا مقصودًا هو “أفول شمس الحكمة”، وجاءت الخاتمة تحت عنوان مقصودٍ آخر هو “بزوغ فجر جديد”، أما الفصول فلم تحمل عناوينَ بل أرقامًا. وتتوزع أحداثها من حيث المكان بين ناريَّا وبيبلوس وجلجامش، ولا تستغرق من الزمان أكثر من عامين، هما اللذان يفصلان بين المقدمة والخاتمة. وقد لجأ المؤلف إلى تقنية المونتاج السينمائي في عرض حوادث روايته، ففصلٌ في ناريَّا، وبعده آخر في جلجامش، ويليهما ثالُ في بيبلوس، وهكذا دواليك في الرواية كلها، يفعل ذلك بصورة تلقائية بسيطة، فلا تداخل في الحوادث ولا تعقيد في التفاصيل، وهو ما يدفع الملل عن القارئ ويجذبه إلى قراءة الرواية من ألفها إلى يائها دون ضجر أو رهَق.
ولا أخفي أنني كنت مشدودًا إلى متابعة أحداثها بلهفةٍ شديدة وفضولٍ غريب، وكان وراء هذا أسلوب الكاتب الشائق ولغته التلغرافية. ولكنني لم أكد أصل إلى الخاتمة حتى سألت نفسي: أين الرواية في كل ما قرأت؟ وأين فكرتها ومغزاها؟ هل ضيعت وقتي بمطالعة أكثر من مائة وثمانين صفحة ليخبرني الكاتب إن الرواية قد انتهت بما بدأت به، وأن لا فائدة من مقاومة الظلم بالحكمة، ولاجدوى من مواجهة الطغيان بالعصيان المدني والاحتجاج السلمي؟! وتمهلت قليلًا قبل أن أصدر هذا الحكم، حتى قرأت السطور الأخيرة التي أثبتها منذ قليل، والتي ذكر فيها المؤلف أن جهاد “نسحو” لم يذهب سُدى، وأن حياته لم تضع هباءً، وأن ما قدمه هو ورفاقه من تضحيات ليكشفوا الحقيقة لأبناء شعبهم لم يكن شيئًا هيِّنًا. لقد فضحوا حكم الكهنة المستبدين، الذين يخدعون الجماهير بطقوس خرافية، ويجعلون من الكاهن ظلَّ الإله في الأرض، فيبطش بمن يشاء كما يشاء.
ثمة بعض الأسئلة عن فكرة هذه الرواية ومغزاها: هل يمكن للحكمة وحدها أن تواجه الظلم وتقضي على دولته؟ هل يمكن للشعوب إذا ما تعلمت الحكمة أن تقف في وجه القوة وتقاومها؟ ثم لماذا لم يحدثنا الكاتب عن العلم، وهو يختلف عن الحكمة كما نعرف؟ لماذا لم يجعل منه سلاحًا آخر يتسلح به الناس في مواجهة سلطان الخرافة والأساطير وهيمنة المتجبرين والمتغطرسين؟ ولعل إجابة هذه الأسئلة تحملها لنا السنوات القا?